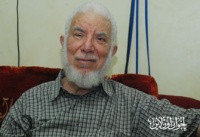الإخلاص.. من رسالة (التعاليم) للإمام حسن البنا (1)
إعداد: وليد شلبي
مقدمة
يُعدُّ الإخلاص من أهم مكونات شخصية الداعية؛ لأنه يُبنَى عليه قبول العمل من عدمه، ولعل من أفضل ما كُتب في الإخلاص ما كتبه الداعية الكبير الأستاذ جمعة أمين في كتابه القيم (الإخلاص من رسالة التعاليم للإمام حسن البنا)، وهو ما سنحاول عرض ملخَّص له هنا؛ لأهمية الكتاب، ولروعة عرضه للإخلاص بطريقة عملية، ذاكرًا دلائل مهمة للإخلاص لكل عنصر من عناصر الدعوة، وقد راعينا في التلخيص عدم الإخلال بالمعنى، وإن كنا اختصرنا بعض الأدلة فقط دون إخلال بالمضمون، والله نسأل أن يرزقَنا الإخلاصَ في القول والعمل وفي السر والعلن.
إن من أخطر ما يؤثر في بناء شخصية المسلم ويقلِّل أو يزيد من فاعليته وحركته من أجل بناء دولته، وتوطيد أركان دعوته: درجة وضوح فكرته، وضوحًا يحدده الفهم الدقيق، والإيمان العميق، والحب الوثيق، والعمل المتواصل، والوعي الكامل.
ولا يكفي هذا الوضوح فحسب، بل لا بد أن يتبع ذلك الإخلاص والعمل الصالح ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبِادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (الكهف: 110)؛ ذلك لأن الإخلاص هو لبُّ العبادات وروحها، فبدونه يصبح العمل كشجرة خبيثة اجتُثت من فوق الأرض ما لها من قرار.
إن الإخلاص إذا شابته شائبةٌ لا يتحقق به نصرٌ، ولا يتوحَّد به صفٌّ، بل تكون الهزيمة محقَّقةً، وانتصار الأعداء لا مفرَّ منه؛ لأنهم أكثر عدةً وعتادًا، ولا ينتصر الضعيف على القوي، ولا القليل على الكثير، ولا الأعزل على المسلَّح إلا بالإخلاص والأخذ بالأسباب ﴿كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ﴾ (البقرة: من الآية 249) وكذلك واصلت الدعوة الإسلامية طريقها وأصبح لها تاريخ ولها أمة لن تموت بفضل الله ثم بفضل رجالها، المخلصين لمنهجهم، المخلصين لجماعتهم، المخلصين لقيادتهم، بعد أن حقَّقوا عقْد الإيمان بينهم وبين خالقهم وعقْد الأخوَّة فيما بينهم بصبر لا ينفد، وعزم لا يلين، وثبات لا يهتزّ، واصطبغوا بصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغةً في كل صغير وكبير، واستعلوا على شهواتهم، ولم تستعبدْهم لذاتهم، ولم تستذلهم أهواؤهم، فإذا أعطوا أعطوا لله، وإذا منعوا فلله.
أخطار تهدد الإخلاص
ولذلك فإن حرارة الإخلاص تنطفئ رويدًا كلما هاجت في النفس نوازع الأثرة وحب الثناء، والتطلع إلى الجاه، وبعد الصيت، والرغبة في العلو والافتخار وحب الظهور، والرغبة في أن يُرى الإنسان في مقدمة الصفوف وأماكن التوجيه؛ ذلك لأن الله يحب العمل النقي من الشوائب المكدرة ﴿أَلاَ للهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ﴾ (الزمر: من الآية 3)؛ من أجل ذلك يقول الرسول- صلى الله عليه وسلم-: "اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء، الذين إن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يُعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة" (رواه الحاكم).
لهذا وجب على الداعي إلى الله أن يجعل عمله منزهًا عن الشوائب، يؤثِر ما عند الله، ويحتسب بدينه ودنياه رِضا الله سبحانه وتعالى، ويتولَّد بهذا الإخلاص أمهاتُ الفضائل ويسودُ الخلقُ الكريمُ، والنهج القويم، والسلوك الحميد، وتنمحي أمهات الرذائل؛ لأن المخلص لدينه صادقٌ مع نفسه، صادقٌ مع ربه، محسنٌ في عمله؛ من أجل ذلك كان من سمات الرعيل الأول صدق الحديث، ودقة الأداء، وضبط الكلام، فتحقق مجتمع العدل والإحسان.
صحة الفهم وحسن القصد
يقول ابن القيم في (إعلام الموقِّعين):
"إن صحة الفهم، وحسن القصد، من أعظم نعم الله التي أنعمها على عبده، بل ما أُعطي عبدٌ بعد الإسلام أفضل وأجلَّ منهما، بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريقَ المغضوب عليهم، الذين فسد قصدُهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومُهم، ويصير من المُنعَم عليهم الذين حسُنَت أفهامهم وتصورهم".
قالوا في الإخلاص
يقول الفضيل بن عياض: "ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يُعافيك الله منهما"، ويقول الجنيد: "الإخلاص سرٌّ بين الله وبين العبد، لا يعلمه مَلَكٌ فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله"، وقال سليمان: طوبى لمن صحَّت له خطوةٌ واحدةٌ لا يريد بها إلا الله تعالى، وقال يعقوب المكفوف: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته.
ركن الإخلاص في رسالة (التعاليم)
يقول الإمام حسن البنا: وأريد بالإخلاص أن يقصد الأخ بقوله وعمله وجهده وجهَ الله، وابتغاءَ مرضاته وحُسْنَ مثوبته، من غير نظرٍ إلى مغنم أو مظهر أو جاه أو لقب أو تقدُّم أو تأخُّر، وبذلك يكون جندي فكرة وعقيدة لا جندي غرض ومنفعة ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ* لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ..﴾ (الأنعام: 162، 163) وبذلك يفهم الأخ المسلم معنى هتافه الدائم: "الله غايتنا" و"الله أكبر ولله الحمد".
معنى الإخلاص
في الدين يضاد الشرك؛ لأن الشرك يشوب الإيمان ويخالطه، فمن ليس مخلصًا فهو مشرك، إلا أن الشرك درجات.. منه ما يُخرِج من الملة وهو الجليّ، ومنه ما لا يُخرِج وهو الخفي الذي أمرنا الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن نستعيذ منه: "اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه".
الإخلاص والنية
بين النية والإخلاص خيط رفيع، فالنية هي القصد وعزم القلب على عمل الفرض أو غيره، أي فعل العبادة تقربًا إلى الله وحده، وإن شئت قلت: النية هي الإرادة الجازمة بحيث تؤدَّى العبادة لله وحده، فلو نطق الإنسان بلسانه دون أن يقصد العبادة بقلبه فلا يكون مؤديًا لها، فمن عبَدَ لغرض دنيوي كأن يُمدح عند الناس، فإذا لم يُمدَح لم يؤدها.. فإنه لا يكون عابدًا، بل إن عبادته لا تصحُّ أو عبَدَ من أجل مالٍ أو شهوةٍ من الشهوات فإن عبادته تكون باطلةً ويعاقَب عليها عقابَ المرائين المجرمين، ومن هنا فإن النية لا بد لها من إخلاص في العبادة مطلقًا، فالمسلم لا بد أن يُخلص في إرادة العبادة.
وهذا شيء آخر غير الخواطر النفسية، كأن يصلي وقلبه مشغول بأمر من أمور الدنيا؛ فإنها لا تفسد الصلاة، وإن كان يجب على المصلِّي الخاشع لربه أن يحاربَ هذه الوساوس بكل ما يستطيع ويخضع لله فيها، فإن عجَزَ عن ذلك ولم يستطِعْ أن ينزع من نفسه أمور الدنيا وهو واقف بين يدي الله فإنه لا يؤاخذ، ولكن عليه أن يستمرَّ في محاربة هذه الوساوس الفاسدة ليظفر بأجر العاملين المخلصين.. يقول الإمام القشيري رحمه الله: "الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر.. من تصنُّع لمخلوق، أو اكتساب محمَدة عند الناس، أو محبة مدح الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى.
الإخلاص لله تعالى
ومعناه منصرف إلى الإيمان ونفي الشرك عنه، وترك الإلحاد في صفاته، ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها، وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص، والقيام بطاعته، واجتناب معاصيه، والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاعه، وجهاد من كفر به، والاعتراف بنعمته، وشكره عليها، وتخليص جميع الأمور من الشوائب كلها.. قليلها وكثيرها؛ حتى يتجرَّدَ فيها قصد التقرب إلى الله تعالى.
الإخلاص لكتاب الله تعالى
أما الإخلاص لكتاب الله- سبحانه وتعالى- فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيهه، لا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حقَّ تلاوته، وتحسينها، والخشوع عندها، والعمل على وضعه موضِعَ التنفيذ حتى يكون منهج حياة.
الإخلاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
الإخلاص له- صلى الله عليه وسلم- أي تصديقه على الرسالة، والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حيًّا وميتًا، ومعاداة من عاداه، وموالاة من والاه، وإعظام حقه وتوقيره، وإحياء طريقته وسنته، وبثّ دعوته ونشر شريعته.
الإخلاص لأئمة المسلمين
الإخلاص لهم أي معاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه، وأمرُهم به، وتنبيهُهم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترْك الخروج عليهم، وتآلف قلوب الناس بطاعتهم.
الإخلاص لعامة المسلمين
عامة المسلمين هم من عدا ولاة الأمر، والإخلاص لهم إرشادُهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكفّ الأذى عنهم، فيُعلِّمهم ما يجهلونه من دينهم، ويُعينُهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم وسدّ خلاّتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم، وتوقير كبيرهم، ورحمة صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة، وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، والذب عن أموالهم. وأعراضهم، وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحقهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع الإخلاص، وتنشيط هممهم إلى الطاعات.
الإخلاص روح الدين
إن روح الدين هو الإخلاص، فبدونه ينعدم أثره؛ لأنه أساس عمل الداعي إلى الله، فلا يرتفع عمل أبدًا ما لم تصحبه نية صالحة، وما لم يقترن بإرادة وجه الله وحده.
الإخلاص يتطلب قوة إيمانية يدفع صاحبه بعد جذبٍ وشد أن يتجرَّد من المصالح الشخصية ويترفع عن الغايات الذاتية لا يبتغي من وراءه جزاءً ولا شكورًا.
فعن أبي أمامه الباهلي- رضي الله عنه-: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر. فقال رسول الله: "لا شيء له؛ إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا ابتغي به وجهه".
وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمَن عمل لي عملاً أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك".
فالإخلاص- إذا- فريضة على كل عابدٍ وهو في محرابه الخاص يتعامل مع ربه فحسب، فإذا اتصل بالدعاة فهو فريضة آكدة وعقد أوثق لأن الداعي في حاجةٍ إلى استدامة ذكر الله ومطالعة وجهه كي يحقق الإخلاص حتى لا يضل الغاية، ولا يحيد عن النهج في زحمةِ الحياة فتزل قدمه بعد ثبوتها.
الإخلاص والأخلاق
إن التوحيدَ الخالص هو دعوة إلى القيم الإنسانية، تلك القيم التي تستخلص من صفات الله جل شأنه وهي: قيم العلم، والحياة، والخلق والإبداع، والغنى في الذات وبالنفس، والقدرة والطاقة على العمل والفعل، والرحمة في موضوع، والشدة حين يدعو الأمر إليها، والعون على المساعدة، والترفع عن الدنايا، والملك والسيادة على النفس وقبل الغير إلى غير ذلك من الصفات الكريمة التي يتصف بها المخلصون لدينهم.
ذلك لأن كل حركة قلبية كالإخلاص لا بد أن يظهر لها أثر على الجوارح لأن الإيمان الخالص يتحول إلى قوة بانية، وطاقة محركة مشرقة معطاءة، لا تتراخى بصاحبها، ولا تتقاعس بهمة الكبار، بل تنطلق باحثة نحو الفضائل والمكرمات ثائرة على الفساد لتقتلعه، وعلى الظلم فترده، وعلى المعروف فتأمر به، وعلى المنكر فتنهي عنه، فيصبح الإيمان الخالص سلاح عزة وقوة.
الباب الأول: من دلائل إخلاص المسلم بوجه عام
لما كان الإيمان وهو حركة قلبية لا بد له من صورة عملية واقعية، يتجلى فيها، ليثبت وجوده، ويترجم عن حقيقته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ليس الإيمان بالتمني، ولا بالتحلي ولكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل".
ومن ثم يرد مثل هذا التعقيب في القرآن لتقرير هذا المعنى الذي يقرره قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتعريف الإيمان وتحديده وإخراجه من أن يكون كلمة تقال باللسان، أو تمنيًا لا واقعية له في عالم العمل والواقع.
ولكي يحقق المسلم الإخلاص في قلبه ويترجمه سلوكًا في حياته يجب أن يضع نصب عينيه أمورًا بينها لنا الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كمعالم على طريق المخلصين يعرفون بها بسيماهم وسلوكهم يراها الناس حياة فيهم فيطمئنون لظاهرهم ويتولى المولى سبحانه وتعالى سرائرهم والعبرة بالخواتيم.
أولاً: صدق النية والإرادة ومراقبة الله تعالى عند كل عمل
وهو ألا يكون له باعث في الحركات والسكنات إلا الله تعالى فإن مازجه شيء من حظوظ النفس بطل الصدق. قال بعض السلف: إني لأستحب أن يكون لي في كل شيء نية حتى في أكلي وشربي ودخولي الخلاء؛ ولذلك كان من دعاء رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ليعلمنا الاعتصام من ملوثات الرياء "اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئًا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه".
فالمخلصون بحق يتحكَّمون في عاداتهم، ويستعلون على شهواتهم، ولا تستعبدهم ملذاتهم، ولا يستلذهم هواهم بصدق النية ومراقبة الله تعالى وإتباع ذلك العمل الصالح. لأن الله لا يقبل عملاً إلا بركنين أساسيين:
1- تصحيح النية وتحقيق الإخلاص.
2- موافقة السنة والشرع.
وبالركن الأول يتحقق صحة الباطن، وبالثاني يتحقق صحة الظاهر، وقد جاء في الركن الأول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات" فهذا هو ميزان الباطن. وجاء في الركن الثاني قوله صلى الله عليه وسلم "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".
وقد جمع المولى سبحانه وتعالى الركنين في آية واحدة فقال: ﴿مَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾.
إن الداعي إلى الله يتعرض في عمله لكثير من المواقف التي لو لم يراقب الله فيها لحبط عمله والعياذ بالله. فهو محدث لبق، فصيح لسن، عالم مقنع. مؤثر جذاب. محبوب محب. شفوق خدوم، خلوق إلى آخر ما يجب أن يتوفر فيه من صفات كريمة، وكل تلك الصفات قد تجره إلى الإعجاب بنفسه، أو الرغبة أن يعجب الناس به. وهذا وذاك طارد للإخلاص، موقع في الرياء، أو النفاق فليكن من ذلك على حذر بمراقبة الله تعالى ليكسر العجب في كل أمر يسلكه وذلك بالآتي:
1- أن يرى التوفيق من الله تعالى.
2- أن ينظر إلى النعماء التي أنعم الله بها عليه، فإذا نظر في نعمائه اشتغل أيضًا بالشكر عليها واستقل عمله ولا يعجب به.
3- أن يخاف أن لا يتقبل منه.
4- أن ينظر إلى ذنوبه التي أذنب قبل ذلك، فإذا خاف أن ترجح سيئاته على حسناته فقد قل عجبه، وكيف يعجب المرء بعله ولا يدرى ماذا يخرج من كتابه يوم القيامة، إنما يتبين عجبه وسروره بعد قراءة الكتاب.
ثانيًا: استصحاب معية الله والتوكل عليه
المسلم الصادق يلجأ إلى ربه في كل أمر من الأمور ويشعر بمعيته.
فإذا مسه الضر قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
وإذا اشتد ظلام لياليه: نادى في الظلمات أن لا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
وإذا اشتد المكر والكيد له قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
وإذا أحس بالوحدة والغربة قال: رب لا تزرني فردٍا وأنت خير الوارثين.
وإذا جمع الناس له قال: حسبنا الله ونعم الوكيل.
وإذا أعيته الحيل قال: إن معي ربي سيهدين.
وإذا أرادوا إفقاره قال: رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير.
وإذا ساوموه على دعوته قال: آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.
وهكذا يستشعر المسلم معية الله في كل حركة وسكنة فينيب إليه ويسلم له قياده: إذ إن المعية تتحقق بالإنابة إليه وهي تتضمن: محبته سبحانه، والخضوع له، والإقبال عليه، والإعراض عمن سواه ولفظة "الإنابة" التي تتحقق بها معية الله، تحمل معنى الإسراع والتقدم. فالمنيب إليه المسرع لمرضاته. والراجع إليه في كل وقت، المتقدم في محرابه للوفاء بالعهد، المستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها.
إن السعادة الدنيوية والأخروية مدارها على هذا الاعتصام بالله، والاعتصام بحبله الذي يعصم من الضلالة، فلا يقع في بدعة أو أي آفة من آفات العمل، والاعتصام به يعصم من الهلكة بالتوكل عليه، والاحتماء به، ثقة فيه سبحانه، واطمئنانًا لأمره دون حرج في النفس كما قال سبحانه ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.
ففي هذه الآية ثلاث مراتب: التحكم- وسعة الصدر بانتفاء الحرج- والتسليم. وهذه هي الاستقامة التي لا تتحقق إلا في معية الله سبحانه وتعالي في الأمور كلها ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾.. فيشعر المسلم أن الخًلق فقراء إلى الله، ضُعفاء بدونه لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا ولا حياة ولا موتًا ولا نشورًا ترى ذلك في موقف موسى عليه السلام يوم أن قال له أتباعه ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ﴾. حين رأوا البحر أمامهم والعدو من خلفهم. لكن موسى عليه السلام أجاب بيقين: ﴿كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِين﴾. ِ
وقالها رسولنا صلى الله عليه وسلم حين خشي عليه أبو بكر الصديق من أعدائه فقال وهو في الغار: لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا؟ قال صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما ﴿لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ وتتحقق المعية بما أخبرنا به ربنا في قوله ﴿وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمْ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمْ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾.
إنه شعور المؤمن بالافتقار إلى الله، والشعور به شعورًا يملك عليه حياته وذلك يحتاج من العبد المخلص:
علم يسوسه، وورع يحجزه، ويقين يحمله، وذكر يؤنسه.
فتتحقق المعية، فإذا تحققت أنزل الله السكينة على عبده وأيده بجنود لم تروها.
إنها سكينة تطمئن بها قلوبهم، وتسكن إليها جوارحهم وتنطق ألسنتهم بالصواب والحكمة، وتحول بينهم وبين قول الخطأ والفحش، واللغو، والهجر، وكل باطل يقول ابن عباس رضي الله عنهما كنا نتحدث إن السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه.
معية الله في الدعاء:
إن المؤمن حين تضيق به الأرض بما رحبت ويظن أنه أحيط به يجأر بالدعاء إلى الله يطلب معيته ويرجو جواره ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾؟ لأن الدعاء استشعار بالضعف الإنساني، واعتراف بالإله القوى، فيناديه العبد الضعيف كي يكون معه يحميه ويحفظه ويرعاه ويكلأه بعنايته، فيتحقق بذلك أسمى أنواع العبودية. إذ الدعاء مخ العبادة، وسمة المخلصين، وسلوك الصادقين، بل والأنبياء والمرسلين المبعوثين رحمة للعالمين. فهم يلجأون إليه في صغير الأمر وكبيره، يقول رسولنا الكريم صلوات الله عليه وسلم "القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل".
ومعية الله تتطلب التوكل عليه، فالمسلم إذا استشعر هذه المعية كان لزامًا عليه أن يتوكل على الله فهو نعم المولى ونعم النصير.
التوكل على الله:
والتوكل على الله شعور بهيمنة الله على الحياة، وبأن حركتها وسكنتها محكومة بحوله وقوته لا يمكن أن تبعد عنه.
واستقرار هذا الشعور في القلب يجعل صلة الإنسان بربه عميقة، وركونه إليه باديًا، لأن التوكل دلالة علم الله وصفاته وما ينبغي له ولذلك فإن المتوكل بهذه اليقظة الفكرية والنفسية أهل لأن يظفر برعاية الله وتوفيقه ومحبته ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾، ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾.
وأصحاب الرسالات أحق الناس بهذا التوكل لأنهم في حاجة إلى ذكر الله والاطمئنان إليه، والإيمان بغيبه، كل ذلك مصدر أُنس وقوة لهم، لأنهم يتعرضون لمخاوف مزعجة، ولا يثبتون فيه على الروع والغبن إلا لأملهم في الله، واستنادهم إليه، وإلا بالتوكل الذي ينير أمامهم ظلمات الحاضر ويجرئهم على مواجهة الجبروت بعزم، وهم يقولون ﴿وَمَا لَنَا أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾.
ذلك لأن القوى الشريرة التي يواجهها حملت الدعوات ليست عدوًا سهلاً. ومكرهم لتزول منه الجبال، فموسى وهارون عليهما السلام عندما أُمرا بالذهاب إلى فرعون لنصحه ودعوته: ﴿قَالا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى (45) قَالَ لا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى (46)﴾ فصحبة الله والتوكل عليه هو المؤنس في هذه الوحشة. وهو المشجع في هذه الرهبة. وذاك معنى التوكل في تلك المواقف.
وهكذا يكون التوكل على الله بحسن الصلة به، فإن حُسن الصلة بالله يُعطي المؤمنين قوةً معنويةً لا يُقدرها إلا الذين يعيشون في هذا المجال الرباني الكريم، إن الله قوي لا يغلبه غالب، عزيز لا تقهره قوة، وحسن الصلة به يُدخل المؤمنين في دائرة العزة و الغلبة، فيشملهم الله بعنايته، ويكلؤهم برعايته، فلا تتغلب عليهم قوة، ولا ينتصر عليهم عدو ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (الطلاق: من الآية ).
فهو السلاح الروحي الذي يجعل من الضعف قوة، ومن القلة كثرة، فمهما كان طغيان الباطل ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (79)﴾ (النمل).
وفي ذكر الله أمره بالتوكل مع إخباره بأنه على الحق دلالة على أن الدين مجموع في هذين الأمرين:
1- أن يكون العبد على حق في قوله وعمله، واعتقاده ونيته.
2- أن يكون متوكلاً على الله واثقًا به.
ففي صحيح البخاري عن ابن عباس- رضي الله عنه- قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين أُلقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه حين قيل لهم ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (آل عمران: من الآية 173).
وفي الترمذي عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- مرفوعًا: "لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصًا وتروح بطانًا".
وللتوكل ثلاث علل تؤثر في كمال التوحيد الخالص:
إحداها: أن يترك ما أُمر به من أسباب، استغناء بالتوكل عنها.
الثانية: أن يتوكل في حظوظه وشهواته دون حظوظ ربه.
الثالثة: أن يرى توكله منَّة.
ثالثًا: الصدق مع الله قولاً وعملاً
الصدق مع الله شكر في السراء وصبر عند البلاء وتوبة عند الذنوب؛ لأن الكمال الإنساني في نظر الإسلام يتم بصدق الحديث، وتحرى الحق، وتنزيه القلب عن أن يخطر به السوء، ولقد سُئل رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: أي الناس أفضل؟ قال: "كل مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا: صدوق السان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقى النقي لا أثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد".
فنقطة البدء في عمل المسلم: تطهير القلب واستقامة اللسان إلا أن الصدق يشتمل على الأعمال الظاهرة والباطنة على حدٍّ سواء.
رابعًا: التحلي بالأخلاق الفاضلة
لا يكون المسلم مسلمًا بحق إلا إذا أخلص دينه، وملأ قلبه نور الهداية، وزكى نفسه بالتقوى فكل ما يصدر عنه هو قبس من نور الإسلام الوضَّاء ، وفيض من ينابيعه الصافية.
فالإخلاص للعقيدة إيمان بالله وتقديس له، ومن شأنه أن يُوقظ حواس الخير، ويربي ملكه المراقبة، ويبعث على طلب معالي الأمور وأشرافها، وينأى بالإنسان عن محقرات الأمور وسفاسف الأعمال.
أولئك يسارعون في الخيرات
ولذلك وجدنا المخلصين في كل زمانٍ و مكان يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وفعل الخيرات من محاسن الأخلاق، فهم الذين قال المولى فيهم: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ (59) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60) أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (61)﴾ (المؤمنون)، فالمتصفون بتلك الصفات الجميلة هم الذين يسارعون في الخيرات والطاعات لنيل أعلى الدرجات وهم الجديرون بها، السابقون إليها.
يقول الإمام الفخر: اعلم أن ترتيب هذه الصفات في نهاية الحسن:
فالصفة الأولى: دلت على حصول الخوف الشديد.
والصفة الثانية: دلت على التصديق بوحدانية الله.
والصفة الثالثة: دلت على ترك الرياء في الطاعات.
والصفة الرابعة: دلت ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ (59) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60) أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (61)﴾على أن المستجمع لتلك الصفات الثلاثة يأتي بالطاعات مع الوجل والخوف من التقصير، وذلك هو نهاية مقامات الصديقين.
هكذا كانوا: صفاءً في القلب، ونقاءً في الضمير، وطهارةً في النفس، وصدقًا في القول، وأمانةً في الأداء، وحفظًا للأعراض والأنفس والأموال، يقول أنس- رضي الله عنه- مخاطبًا بعض التابعين: "إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها في عهد رسول الله من الموبقات".
فأين نحن إذًا من صدق الصديق، وعدل عمر، ونبل عثمان، وبسالة علي، وفروسية خالد، وحنكة عمرو، وحلم معاوية، وإقدام ابن الزبير؟!
إن المخلصين أصبحوا بهذه الأخلاق أقرب الناس مجلسًا لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة، كما أخبرهم بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم: "إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافًا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إليَّ وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون".
خامسًا: الوقوف عند الحلال والحرام واتقاء المتشابه
عن النعمان بن بشير أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبينهما مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراعٍ يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب".
فالمتأمل في هذا الحديث الشريف يسأل نفسه، مَن مِن المؤمنين المخلصين يجهل أمر الحلال والحرام؟ وهو أمر يُعلم من الدين بالضرورة؛ لأن الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفي عنه.
سادسًا: التدقيق في اختيار الصديق
اختيار الأصدقاء الذين يعينون على الخير، ويرشدون إليه، مما يهتم به الإسلام ويحرص عليه أشد الحرص، إذ الإنسان يفيد بمعاشرة الأصدقاء كثيرًا مما هو في حاجة إليه من جميل الخصال، وتهذيب السلوك، وصقل النفس.
يقول عمر بن عبد العزيز- رضي الله عنه-: "مَن أراد أن يصحبنا فليصحبنا بخمس: 1- يوصل إلينا حاجة من لا تصل إلينا حاجته.
2- ويدلنا من العدل ما لا نهتدي إليه.
3- ويكون عونًا لنا على الحق.
4- ويؤدي الأمانة إلينا وإلى الناس.
5- ولا يغتب عندنا أحدًا.
ومن لم يفعل فهو في حرجٍ من صحبتنا والدخول علينا".
سابعًا: تفقد القلب ومحاسبة النفس
كل ما ذكرناه من دلائل الإخلاص يحتاج من المسلم إلى وقفةٍ مع القلب يتفقده خشية أن يعتريه ميل أو زيغ، أو حسد أو حقد أو ضغينة، أو سوء ظن، أو غيبة أو نميمة، كما يحتاج إلى وقفةٍ مع النفس يحاسبها عمَّا طرأ عليها من كبرٍ أو بطر أو شر حتى يحافظ على استمراريةِ إخلاصه لدينه.
ولسائلٍ أن يسأل وما أهمية هذه الوقفة؟ إنها وقفة تفقدية؛ لأن رسالةَ الإسلام، رسالة تربية قبل أن تكون رسالة تشريع ونظام، ورسالة أخلاق قبل أن تكون رسالة جهاد وقتال، ورسالة سمو وقيم قبل أن تكون رسالة اتساع وانتشار؛ ولهذا فنحن في حاجةٍ إلى هذه الوقفة مع النفس والقلب.
تفقد القلب ومحاسبة النفس
إن معاصي القلوب أخطر من معاصي الجوارح لا يشك مسلم فاهم لدينه في ذلك؛ لأن الأكل من الشجرة المحرمة- كما فعل آدم عليه السلام- معصية، دون التكبر على الله كما فعل إبليس اللعين، فيجب على المسلم أن يتفقد مواطن قلبه التي يجول فيها وهي ثلاثة سافلة وثلاثة عالية.
فالسافلة: دنيا تتزين له، ونفس تحدثه، وعدو يوسوس له.
والثلاثة العالية: علم يتبين، وعقل يرشده، وإله يعبده.. والقلوب جوالة في هذه المواطن.
وسلامة القلب لا تتم مطلقًا حتى يسلم من خمسة أشياء:
1- من شرك يناقض التوحيد.
2- وبدعة تخالف السنة.
3- وشهوة تخالف الأمر
4- وغفلة تناقض الذكر.
5- وهوى يناقض التجرد والإخلاص.
قال رجل للحسن: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي، قال: أذبه بالذكر.
وسأل رجل السيدة عائشة- رضي الله عنها-: ما دواء قسوة القلب؟ فأمرته بعيادةِ المرضى وتشيع الجنائز، وتوقع الموت.
كما شكا رجل من ذلك إلى مالك بن دينار، فقال أدم الصيام، فإن وجدت قسوة فأطل القيام، فإن وجدت قسوة فأقل الطعام.
وقال الأزدي سمعت إبراهيم الخواص يقول: دواء القلب خمسة أشياء:
1- القرآن بالتدبر.
2- وجلاء النظر.
3- وقيام الليل.
4- والتضرع عند السحر.
5- ومجالسة الصالحين.
ضرر الذنوب
ولا شك أن ضرر الذنوب على القلب كضرر السموم على الأبدان، فهي تضعف في القلب تعظيم الرب، فلو تمكَّن وقار الله وعظمته في قلبٍ لما تجرَّأ على معاصيه، والذنب إما يميت القلب أو يمرضه مرضًا مخوفًا، أو يضعف قوته، ولا بد كي ينتهي ضعفه من أن يتخلص من الثمانية التي استعاذ منها النبي- صلى الله عليه وسلم- وهي: "الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وغلبة الدين، وقهر الرجال".
محاسبة النفس
إذا كان تصحيح النية قبل العمل، والمراقبة عند العمل، فإن المحاسبة تأتي بعد العمل، فعن شداد بن أوس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني".
ولما كانت النفس مطية العبد الذي يسير عليها إلى الجنة أو النار كان لا بد من معرفةِ طبيعتها حتى نتعامل معها، فهي لها قوتان قوة إقدام، وقوة إحجام، فلا بد للعبد أن يجعل قوة الإقدام مصروفه إلى ما ينفعه، وقوة الإحجام إمساكًا عما يضره.
ومحاسبة النفس نوعان:
1- قبل العمل:
وهو أن يقف المسلم عند أول همه وإرادته، ولا يبادر بالعمل حتى يتبيَّن له رجحانه على تركه.
قال الحسن رحمه الله تعالى: رحم الله عبدًا وقف عند هَمَّه، فإن كان لله مضى، وإن كان لغيره تأخَّر.
ولكي يُحقق ذلك يسأل نفسه هذه الأسئلة:
1- هل هذا العمل مقدور له أو غير مقدور ولا مستطاع؟
2- هل فعله خير له من تركه أو تركه خير له من فعله؟
3- هل الباعث عليه إرادة وجه الله عز وجل وثوابه أو إرادة الجاه والثناء والمال والمصلحة من المخلوق؟
4- هل له أعوان يُساعدونه وينصرونه إذا كان العمل مُحتاجًا إلى ذلك أم لا؟
2- بعد العمل:
وهي ثلاثة أنواع:
أولاً: محاسبتها على طاعة، قصرت فيها من حق الله تعالى، فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي، وحق الله تعالى في الطاعة ستة أمور هي:
1- الإخلاص في العمل.
2- النصيحة لله فيه.
3- متابعة الرسول فيه.
4- شهود مشهد الإحسان فيه.
5- وشعور منة الله عليه.
6- شعوره بالتقصير فيه بعد ذلك كله.
ثانيًا: أن يحاسب نفسه على أمرٍ مباح أو معتاد: لِمَ فعله؟ وهل أراد به الله والدار الآخرة؟ أم أراد به الدنيا وعاجلها؟
وجماع ذلك:
أن يحاسب نفسه أولاً على الفرائض فإن تذكَّر فيها نقصًا تداركه ثم يحاسبها على المنهي فإن زلت قدمه فيها تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، ثم يحاسب نفسه على الغفلة ويتداركها بالذكر والإقبال على الله، ثم يحاسبها بما تكلَّم به، أو مشت إليه رجلاه، أو بطشت يداه، أو سمعته أذناه، ماذا أردت بهذا؟ ولمن فعلته؟ وعلى أي وجهٍ فعلته؟ كل ذلك قبل أن يُسأل في ﴿يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ (88) إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89)﴾ (الشعراء) ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (93)﴾ (الحجر).
النفس والهوى
ولا تحسبن محاسبة النفس بالأمر الهين لا يُكلف الإنسان إلا استعراض ما فعله وكفى، إنه جهدٌ وجهادٌ يسبق المجاهدة؛ ذلك لأن النفس مجبولة على حب الهوى مفتقرة إلى المجاهدة والمخالفة "الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني" (رواه الترمذي)، وأفضل الأعمال ما أُكرهت عليه الأنفس، "فالمجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل" (الترمذي).
إن من ملك نفسه عز، ومن ملكته نفسه ذل، ومن صبر على مخالفة نفسه أوصله الله إلى مقام أُنسه.
إن المولى سبحانه حذر خيرة خلقه من الهوى.. ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعْ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (ص: من الآية 26) ويقول لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ﴿وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ﴾ (البقرة: من الآية 120).
ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا مَن جاهد هذه الأعداء باطنًا، فمن نُصر عليها نُصر على عدوه، ومن نُصرت عليه نُصر عليه عدوه.
فلا تكن من الغافلين:
إن العبد إذا تيقظ فحاسب نفسه وتبين له تقصيره وخطأه ندم، وتاب واستغفر، محا الله سيئته، وأنسى جوارحه ما عملت، ومسح آثار معصيته حتى يلقى الله وليس عليه شاهد بذنب، وصدق المولى إذ يقول ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ (هود: من الآية 114).
إن يقظة الضمير أو النفس، ودقة الشعور، وحياة الوجدان جعلها الإسلام قوام صلاح النفس، فهي الحارس الذي يحصي على المسلم خواطره وهواجسه، وألفاظه، وكلماته، وأعماله، وتصرفاته؛ لأنه لا يفارقه لحظة من ليل أو نهار في خلوة أو اجتماع، ويزنه بميزان دقيق يميز الخير من الشر ويعلن الجزاء لساعته مسرورًا ومبتهجًا برضي وطمأنينة وراحة وسلامًا إذا فكر أو قال أو فعل خيرًا، وسعيرًا وجحيمًا ووخزًا أليمًا ونارًا تلظى بين الضلوع والجوانح إذا انحرف عن الطريق أو ضل سواء السبيل حتى إنه ليفر بنفسه إلى القصاص العادل وإن كان الموت, كما حدث في قصة ماعز والغامدية.
إنها اليقظة في نفس المؤمن أصاب أم أخطأ: معرفة بالله, وإحساس برقابته ليفوز بجنة الآخرة ولا يحظى بذلك إلا المخلصون.
الباب الثاني: من دلائل الإخلاص للدعوة (المنهج) جندًا وقيادةً
فهمٌ لا غنى عنه يتحدد به المعنى الشمولي للإخلاص
إن إخلاص القلب، ونقاء الضمير، وطهارة النفس، وصدق القول، وأمانة الأداء.. كلها من مكارم الأخلاق التي بُعث الرسول- صلى الله عليه وسلم- ليتمَّها، وليكوِّن بها اللبنات الصالحة في مجتمعه، وعلى امتداد الأحقاب والقرون لم تخلُ أمةٌ من الأمم من مثل هذه اللبنات التي تتمثل في بعض الأفراد الصالحين أو العباد الزاهدين أو الدعاة المخلصين، وحتى أقسى الأمم وأكثرها سوءًا لا يمكن أن تخلوَ من بعض الأفراد الذين إذا ذُكر الله وجلت قلوبهم، ومن يعرفون الخالق بالمخلوق، والمنعم بالنعم، والحكيم بالحكمة، ويتحلون بالأخلاق الحميدة.
والعبرة في حركة التاريخ أو في نموّ الحضارة وازدهارها ليست بوجود الأفراد المخلصين الذين يتصفون بهذه الأخلاق مهما بلغ صلاحهم وتقواهم وإدراكهم لحقائق الأمور، وإنما العبرة والأهم أن تكون هناك حركةٌ جماعيةٌ، وصلاحٌ يشبه أن يكون تيارًا قويًّا هادرًا غالبًا، لا ضعيفًا ولا مغلوبًا، مؤثرًا في غيره بالتعريف بدعوته بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، لا يتأثر بغيره.. يقول الحق بعزة المؤمن الذي يستمد قوته من الله ثم من الجماعة التي يرتبط بها.
وليس هذا تقليلاً من عمل الفرد ولا ما يتحلى به من صفات كريمة، ولكن إحقاقًا للحق الذي ندين به، ذلك لأنه إذا لم ينجح الفرد المخلص في تحويل دعوته إلى تيار عام يحمله المخلصون أمثاله، ويعتصمون بحبل الله ويكونون على قلب رجل واحد في جماعة واحدة كان من الخاسرين ﴿وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)﴾ (العصر)، فالاستثناء من الخسران للجماعة التي تتواصى بالحق والصبر وليس للفرد ولو كان مخلصًا.
فليست عناية الإسلام بالفرد إلا ليكون لبنةً صالحةً في الجماعة التي ستتحمَّل عبء الدعوة من حيث نشرها، والجهاد في سبيل نصرتها وإقامة الدولة التي دعا الإسلام لتشييدها، وتدعيم أركانها.
فالإخلاص الذي يتحلَّى به المسلم ليس لذاته وإن كان مثابًا عليه كفرد؛ لأن صلاح المسلم وإخلاصه في ذاته كالماء الطاهر، فهو طاهر في ذاته غير مطهِّر لغيره، والإسلام يطلب من المسلم أن يكون طهورًا وليس طاهرًا فحسب؛ ليكون طاهرًا في ذاته مطهِّرًا لغيره، فلا بد أن يكون لبنةً صالحةً يتحلى بأخلاق المسلمين؛ لأنه لا يمكن أن يسود التآلف والترابط والمحبة والتعاون والإيثار، وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة التي هي دليل على الإخلاص، ولا يتم التوافق الاجتماعي.. إلا إذا وُجدت الوحدة الأخلاقية، ووُجد اتفاق بين الأفراد في السلوك والاتجاه وفهم الأخلاق، وكل ذلك لا يتحقق إلا بالفهم الشامل للإسلام، لذلك قدم الإمام الشهيد حسن البنا ركن الفهم على ركن الإخلاص- في أركان البيعة- فالمسلم لا بد أن يفهم أولاً دعوته فهمًا دقيقًا؛ حتى يكون إخلاصه لهذا الفهم إخلاصًا قائمًا على العلم المحكم.
الفهم الذي نخلص له
والإخوان المسلمون يفهمون الإسلام فهمًا نقيًّا صافيًا، سهلاً شاملاً كافيًا وافيًا، يساير العصور ويفي بحاجات الأمم، ويجلب السعادة للناس، بعيدًا عن جمود الجامدين، وتحلُّل الإباحيين وتعقيد المتفلسفين، لا غلوَّ فيه ولا تفريطَ، مستمَدًا من كتاب الله وسنة رسوله وسيرة السلف الصالحين، استمدادًا منطقيًّا منصفًا، بقلب المؤمن الصادق، وعقل الرياضي الدقيق، عرفوه على وجهه.. عقيدةً وعبادةً، ووطنًا وجنسيةً، وخلقًا ومادةً وسماحةً وقوةً، وثقافةً وقانونًا، واعتقدوه على حقيقته.. دينًا ودولةً، وحكومةً وأمةً، ومصحفًا وسيفًا، وخلافةً من الله للمسلمين في أمم الأرض أجمعين ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (البقرة: من الآية 143).
لهذا الفهم يكون إخلاصنا، فالإسلام- كما تفهم- دين الجماعة يربي الفرد ليكون مصلحًا لا صالحًا فحسب؛ لأن الصالح والفاسد لا يتعدى ذاته، ولكن المصلح والمفسد يتعدَّى الذات إلى الغير ﴿ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ (131)﴾ (الأنعام) ويقول سبحانه: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ﴾ (البقرة: من الآية 220).
إخلاص الفرد لا يكفي
إن العمل الفردي في واقع الأمة الإسلامية المعاصر لا يكفي لسدِّ الثغرة، وتحقيق الأمل المرتجَى، بل لا بد من عمل جماعي، وهذا ما يُوجبه الدين ويحتِّمه الواقع.
وهكذا يكون العمل الجماعي منظَّمًا يقوم على:
1- قيادة مخلصة مسئولة (القيادة).
2- قاعدة (الأفراد) مترابطة فيما بينها مخلصة لبعضها (الجماعة).
3- منهاج بمفاهيم واضحة (الدعوة).
وتقوم العلاقات المحددة فيما بينها على أساس من الشورى الواجبة الملزِمة، والطاعة المبصرة اللازمة، فإن لم يرتفع الإخلاص فيما بينها أصبحت كأيِّ تجمع قائم على المصالح والمنافع، وليست جماعةً لها مقوماتُها وخصائصُها وأهدافُها ووسائلُها، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله؛ لتحقق الخيرية في زمانها الذي تعيشه وتقود البشرية إلى رشدها، وتحقق قوله تعالى﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (البقرة: من الآية 143).
فالمؤمنون الذين يجمع الله بينهم وبين من تاب وأصلح واعتصم بالله وأخلص دينه لله هم المخلصون لله في عبادتهم، المتبرئون من كل ما سواه، وهم المخاطبون مع النبي- صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدْ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2)﴾ (الزمر) وهم المطالَبون بالإخلاص في قوله ﴿هُوَ الْحَيُّ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (65)﴾ (غافر) وفي قوله ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5)﴾ (البينة)
ومن هنا كان إخلاصنا فيه الشمول أيضًا لا يقف عند حد الإخلاص الفردي- الذي بينَّاه سابقًا- ولكن يتعدى ذلك للمنهج (الدعوة)- والإخلاص للجماعة- (أفرادًا وقيادةً).
إن الإسلام دين الجماعة في عقيدتها وعبادتها، وشريعتها وأخلاقها، فكان لا بد أن يكون المسلم مخلصًا لهذه الجماعة..
أولاً: لتصوراتها ومعتقداتها.
ثانيًا: لأهدافها وغاياتها.
ثالثًا: وسائل تحقيقها للأهداف والغايات.
حتى تتوحد صفوف الجماعة بوضوح الفكرة، ووحدة التصور والسلوك، ووحدة الهدف والمصير، ووحدة الغاية ووسائل تحقيق ذلك كله.
إخلاص الأفراد والقيادة للدعوة
لقد طغت اليوم على الناس من العادات وأسلوب الحياة والتعامل- التي أصبحت مألوفة إلى نفوسهم- ما ورثوه من تقليد الشرق أو الغرب، والتي تتصادم مع قواعد الشرع وأحكامه وآدابه، وأصحاب الدعوة ينبغي أن لا تستخفَّهم أهواء البشر، فالرغبة في الاستجابة لهذه الأهواء هي التي تقود بعض الدعاة اليوم إلى محاولة تحوير العقيدة أو محاولة تحوير النظام الإسلامي في صورة تتناسب مع الأوضاع الشاذَّة اليوم.
إن المخلص لدعوته لا بدَّ أن يستعلي بدينه، فلا يستجيب لأي منهج آخر غير الإسلام، ولا يحاول تزيين هذا الدين بغير اسمه وعنوانه، ولا مخاطبة الناس بغير منهجه ووسائله النبيلة، فالله غني عن العالمين، ومن لم يستجب لدينه عبوديةً له وانسلاخًا من العبودية لسواه فلا حاجةَ لهذا الدين به، كما لا حاجة لله سبحانه بأحد من الطائعين أو العصاة.
إن على الدعاة المخلصين ألا يتخذوا وسائل وأساليب لا تستقيم مع موازين الدعوة ولا مع منهجها المستقيم، وأن لا يحملهم حرصهم على سرعة انتصار الدعوة وانتشارها أن ينجرفوا بها عن منهجها الصحيح ولو يسيرًا، فمصلحةُ الدعوة الحقيقية في أن يستقيم الدعاة إلى الله على منهجها، وأن يسيروا بها على هدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ولا ينبغي الاهتمام بالنتائج وقطف الثمار أكثر من الاهتمام بالأسلوب الصحيح الذي تسير عليه الدعوة، وأما النتائج فغيبٌ لا يعلمه إلا الله، والخير في نهاية المطاف- عاجلاً أو آجلاً- لا بد منه بإذن الله ﴿كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (21)﴾ (المجادلة) فكان لا بد من دلائل للإخلاص للدعوة.
من دلائل الإخلاص للدعوة
1- الإخلاص في تمحيص مصدر التلقي
يجب الحذر الشديد من الافتتان ببعض علماء السوء، الذين ارتموا في أحضان الحكام، ونالوا عندهم الحظوة، واطمأنوا إلى المتاع الذي يلقونه بين أيديهم، وصاروا لهم أطوعَ من البَنان، لا يألون جهدًا في النزول عن رغباتهم، كل ذلك من أجل تملق الحكام، وتقديم البرهان على كمال الطاعة والانقياد لهم.
فلا بد من البحث عن قائل يقول كلمة الحق، ويبصِّر الناس بدينهم ويميِّز للناس الضلال من الهدى، يردّهم عن الشهوات، ويوضّح لهم الشبهات، ويتسلّح بالعلم، ويتزيّن بالحلم ويتجمّل بالحكمة، ويتحلّى بالصبر، ويقول للناس حسنًا، ويجادل بالتي هي أحسن، واثقًا بالله، متوكلاً عليه.
فالمخلص لدعوته ودينه يبذل الجهد للوصول إلى هؤلاء ليتلقَّى منهم دينه وينضمّ إلى صفوف أتباعهم، وينبذ من دونهم؛ لأن الحق سبحانه قال في أمثالهم﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (187)﴾ (آل عمران).
2- إعلان الدعوة والجهر بها والاستمساك بمنهجها دون إفراط أو تفريط
إن الرسول- صلى الله عليه وسلم- لم يستمسك بالذي أوحي إليه فحسب، بل كُلِّف- صلى الله عليه وسلم- أن يعلنها للناس إعلانًا عامًّا، وأن يلقي إليهم بالكلمة الأخيرة الحاسمة أنه ماضٍ في خطته، مستقيمٌ على طريقته حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، فصاحب الدعوة يثبُت على منهاجه ودعوته، ويسير طريقه لا يحفل بما كان من أعدائه وما سيكون، فهو دائمًا مطمئنُّ القلب؛ لأنه على صراط مستقيم لا يلتوي ولا ينحرف ولا يحيد.
حذارِ من الفتنة بترك بعض المنهج
فليستقِم المؤمنُ بدين الله، والداعون له على طريقتهم كما أمروا، لا يغلوا في الدين، ولا يزيدوا فيه، ولا يركنوا إلى الظالمين مهما تكن قوتهم، ولا يدينوا لغير الله مهما طال عليهم الطريق، ثم ليتزودوا بزاد الطريق، ويصبروا حتى تتحقق سنة الله عندما يريد سبحانه وهم مستمسكون بمنهجهم دون زيادة أو نقصان ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ (44) لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47)﴾ (الحاقة).
إن المؤمن المخلص لدينه على حذرٍ من أن يفتنه بعض أعداء الدين عن بعض هذا المنهج ﴿وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ (المائدة: من الآية 49) وما عليه إلا أن يستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، فالإفراط والغلوّ يخرجان هذا الدين عن طبيعته كالتفريط والتقصير، وهي التفاتة ذات قيمة لإمساك النفوس على الصراط، وهذا هو الإخلاص بعينه للمنهج الرباني.
3- احترام أهل التخصص والسابقين في الدعوة
إن سعي المسلم الدائم لتلقي إسلامه من المصادر المخلصة يرجع إلى إخلاصه لهذه الدعوة، حتى يتلقاها بعيدًا عن الأهواء، بعيدًا عن العاطفة والمجاملات الشخصية؛ ولذا وجب عليه أن يطمئن إلى كفاءة من يتلقَّى عنه اطمئنانًا ينتج عنه الحب والتقدير والاحترام والطاعة، فعلى قدْرِ هذه الثقة يكون التلقِّي حتى لو لم يدرك المتعلم أغوار ما يتعلمه؛ ذلك لأن المخلص لدينه لا بد أن يكون تلميذ إمام لا تلميذ كتاب، فلا يتعامل مع نصوص الكتاب والسنة مباشرة، ولكن يلجأ إلى عالم متخصص عامل لدينه، أو داعية مشهود له بالفهم الدقيق، والإيمان العميق والعمل المتواصل، والوعي الكامل، والثبات على الحق، والخلق الجمّ حتى يحذرَ علمًا يلتبس بإفراط يزيد بدعةً، أو تفريطًا يهمل أمرًا أو إرشادًا لا يهدي الطريق.
لذا وجب على المخلص أن يبحث عن ذوي الخبرة والتجربة والعلم بالدين ليُعصَم من زلل الاستعجال، ومحاولة قطف الثمرة قبل نضجها، واستعجال النتائج، أو اجتزاء المنهج؛ لأن طبيعة الرسالة الخاتمة- ومن لوازمها- أن تستمر بعيدةً عن التحريف والتأويل، والنقص والضياع، ليتسلمَها المسلم كما أُنزلت على محمد- صلى الله عليه وسلم- حتى يتم التكليف سليمًا صحيحًا وتترتب المسئولية بهذا الوضوح، ولا يتحقق ذلك إلا باحترام أهل التخصص والسبق والتلقِّي منهم؛ حفاظًا على استمرارية الدعوة.
4- انطباق السلوك مع ما يدعى إليه والأخذ بالعزائم لتحقيق القدوة
وهذا يتطلَّب من المسلم الصادق أن يُفاصل مجتمعه شعوريًّا فيما يُغضِب الله، فلا يشاركهم السلوك ولا الاعتقاد، وفي نفس الوقت يخالطهم ويصبر على أذاهم حين يدعوهم ويبين لهم دين الله، وبذلك يجنِّد قواه لنصرة هذا الدين دون ملل أو كلَل، مستجيبًا لأمر الله ﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (15)﴾ (الشورى).
فإذا استمع لمن يقول: من أنصاري إلى الله؟! قال مع القافلة المؤمنة: "نحن أنصار الله" لتجتمع كلمتهم على الحق ونصرته؛ لأن عزائم الرجال هي التي تصنع الأمم، فهم لا يترخَّصون إلا متحرِّفين لقتال أو متحيزين لفئة أو لرفع حرج شرعي؛ لأن اتباع الناس للدين وعملهم به بمقدار تصلب المخلصين، وتمسكهم بالحق، فإن اهتمَّ هؤلاء بالنوافل والفرائض اهتمَّ الناس بالنوافل، فإذا اكتفى المخلصون بالفرائض استرسل الناس لتركها والاستهانة بها.
فيجب أخذ الأمر بقوة عزيمة، والأخذ باليسير أو الأيسر دعوةً، وبالعزائم قدوةً، وللأخذ بالرخص أحوال "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"، والدعاة المخلصون ينبغي أن يأخذوا أنفسهم بالعزائم في أكثر أحوالهم؛ لأنهم نصَّبوا أنفسهم للناس قدوةً، والناسُ لهم أتباعٌ، وما أحوج الناس إلى أئمة يدعون إلى الله على بصيرة وهم متوكلون.
فالمخلصون هم أبعد الناس عن التصنُّع، وأحرصُهم على الكمال؛ لأن أدنى هفوة منهم تُسقط اعتبارهم وتسهل التهاون بهم، فلا يكون لكلامهم تأثير في القلوب، ولهذا كانت وصية الإمام الشافعي لمؤدِّب أولاد هارون الرشيد: "ليكن أول ما تبدأ به إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاح نفسك، فإن أعنَّتهم معقودة بيدك، فالحسن عندهم ما استحسنته، والقبيح عندهم ما تركته"، وقال الإمام علي رضي الله عنه: "من نصَّب نفسه للناس إمامًا، فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تهذيبه بسيرته قبل تهذيبه بلسانه، ومعلّم نفسه ومهذّبها أحقُّ بالإجلال من معلم الناس ومهذبهم".
5- التجرد من التفكير في المنافع المادية والثمرات العاجلة والمصالح الشخصية والانتفاع من الدعوة
إن أمَارة الإخلاص للدعوة إلى الحق وإلى السلوك السوي والمستوى الإنساني الكريم هي ألا يشرك الداعي إلى الله شيئًا آخر معه، أمارة هذا الإخلاص أن تكون الدعوة للحق وحده، وفي سبيله، ولا يبغي بالدعوة إليه نفعًا يعود عليه خاصة؛ لأنه إذ يشرك مع الحق أمرًا معه في الدعوة يكون قد أشرك الشيء وضده؛ لأن ما عدا الحق باطل وزيف ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ (32)﴾ (يونس) وإذا اختلط الحق مع الباطل في دعوة باسم الحق التبَس الأمر على من توجه إليه الدعوة، وعندئذ يفسد الوضع كله، فوق ما ينال الداعي من آثار لفساد دعوته.
فحريٌّ بصاحب الدعوة- إن كان مخلصًا بحق- أن يبتعد في مباشرته للدعوة عن أن يحقِّق عن طريقها رغبةً أو مصلحةً أو فائدةً شخصيةً يسعى إليها من خلال دعوته، أو يتخذ منها سببًا للجاهِ والشرف والرياسة أو ينفع بها قريبًا في نسب أو بعيدًا في حسب.
وحين يتمكن الإخلاص من القلوب لا يحفل المرء بما يفقده من مال أو جاه أو سلطان، بل لا يبالي بما يقع عليه من عذاب؛ لأن القلب الذي اتصل بالله وذاق طعمَ العزَّة لم يعُد يحفل الطغيان، والقلب الذي يرجو الآخرة لا يهمه من أمر هذا الدنيا قليلٌ ولا كثيرٌ؛ ولذلك قالوا: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (72) إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا﴾ (طه).
والطغاة يَعرفون صدق الداعي وإخلاصَه لدعوته من كذبه حينما يقدِّمون عروضًا مغريةً بالأموال والهبات، فإذا ما قبل الداعي شيئًا من ذلك عُرف بأنه من طلاَّب الدنيا وأنه لبسَ مسوحَ الدعاة للوصول إلى أهداف محددة، وبالتالي فهم ليسوا مخلصين لدعوتهم.
ذلك لأن الداعي إلى الله يعلم أنه في كل زمان ومكان قد تستهوي زينة الأرض بعض القلوب، وتبهر الذين يريدون الحياة الدنيا، ولا يتطلعون إلى ما هو أعلى وأكرم منها، فلا يسألون بأي ثمن اشترى صاحب الزينة زينته؟! ولا بأي الوسائل نال ما نال من عرض الحياة؟! من مال أو منصب أو جاه، ومن ثم تتهافت نفوسهم وتتهاوَى كما يتهافت الذباب على الحلوى ويتهاوى!! ويسيل لعابهم على ما في أيدي المحظوظين من متاع، غير ناظرين إلى الثمن الباهظ الذي أدَّوه، ولا إلى الطريق الدنس الذي خاضوه، ولا إلى الوسيلة الخسيسة التي اتخذوها.
إن إخلاص الداعي يكون أدعى لقبول الناس للدعوة، وأقطعَ بطمع العدو في استمالتهم إليه، وأدلَّ على صدق الداعية، صدقه فيما يدعو الناس إليه، وصدق نفسه مع دعوته، التي حملت هذه الدعوة فكرًا وأسلوبًا وسمتًا، وأنه لم يحملها ليحترَّف بها ويبتغيَ من ورائها المكاسب المادية، ولا ليصبح أداةً مسخرةً في أيدي أصحاب السلطان، ولا بَوقًا من أبواقهم ينافح عنهم ويدافع عن ظلمهم وسيئاتهم، وإلا فإنه سيحترَّق وينتهي، وتوصَد القلوب دون دعوته، مهما دعا إلى حق، ومهما تظاهَر بالصلاح، ولبس مسوح الرهبان، وقد يصبح قدوةَ سوءٍ، وفتنةً للناس، ومضرب مثل للنفاق والتصنُّع للسلطان، والتزلُّف بين يديه والمتاجرة بالدين.
يقول ابن عطاء السكندري: ما بسقت أغصان إلا على بذور طمع، فالإنسان يكون في أشرف أحواله عندما يدعو إلى الله ويتبتل إليه، فلا يرجو ولا يأمل مما سواه، فماذا يرجو الفقير من فقير مثله؟!
ولقد عبر الشهيد حسن البنا- رضوان الله عليه- عن ذلك أحسن تعبير، حين كتب لبعض باشاوات عصره يعرِّفه بالإخوان يقول: "والإخوان المسلمون يا رفعة الباشا لا يقادُون برغبة ولا برهبة، ولا يخشَون أحدًا إلا الله، ولا يُغريهم جاهٌ ولا منصبٌ، ولا يطمعون في منفعة ولا مال، ولا تعلق نفوسهم بعرض من أعراض هذه الحياة الفانية، ولكنهم يبتغون رضوان الله ويرجون ثواب الآخرة، ويتمثَّلون في كل خطواتهم قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَفِرُّوا إِلَى اللهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ (الذاريات: 50).
فهم يفرون من كل الغايات والمطامع إلى غاية واحدة ومقصد واحد هو رضوان الله، وهم لهذا لا يشتغلون في منهاج غير منهاجهم، ولا يصلحون لدعوة غير دعوتهم، ولا يصطبغون بلون غير الإسلام ﴿صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً﴾ (البقرة: من الآية 138)، فمن حاول أن يخدعَهم خُدِعَ، ومن أراد أن يستغلَّهم خَسِر، ومن طمع في تسخيرهم لهواه أخفَق، ومن أخلص معهم في غايتهم ووافقهم على متْن طريقهم سعد بهم وسعدوا به، ورأى فيهم الجنود البسلاء والإخوة الأوفياء، يفدُونه بأرواحهم ويحوطونه بقلوبهم وجهودهم، ويرون له بعد ذلك الفضل عليهم (رسالة المؤتمر الخامس).
6- تحمُّل الإيذاء في سبيل الدعوة وبذل المال والنفس والجهاد لنصرتها
يتعرض أفراد الجماعة المسلمة- وهي تسير في طريق الله- إلى الأذى في النفس والمال والولد، فتحتاج إلى صبر عند جهاد المشاقين لله، وعند النصر عليهم، وتحتاجه عند ثقل الحمل وقلة المعين، وتحتاجه عند تأخر النصر وطول الطريق، وتحتاجه عند التواء النفوس وضلال القلوب.
هذه هي طبيعة الطريق إلى بناء الرجال الذين يحملون هذه الأمانة ليكونوا على بصيرة من أمرهم قبل وُلُوج تلك الطريق، ويتعرَّفوا على أنواع الفتن التي سيتعرضون لها، وقد لخَّص الشهيد سيد قطب أهمَّ تلك الأنواع وهي:
1- من الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله، ثم لا يجد النصير الذي يسانده ويدفع عنه.
2- ومن الفتنه فتنة الأهل والأحباء الذي يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه، وهو لا يملك عنهم دفعًا وهم يهتفون به ليسالم، وينادونه باسم الحب والرحِم واتقاء الله في الرحِم التي يعرضها للأذى والهلاك.
3- ومنها فتنة إقبال الدنيا على المبطِلين، ورؤية الناس لهم ناجحين، تهتف الدنيا لهم، وتصفق الجماهير، والمؤمن مهمَل منكَر لا يحسُّ به أحدٌ، ولا يحامي عنه أحد.
4- ومنها فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة، حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله غارقًا في دنيا الضلالة، وهو في طريق غريب.
5- ومنها فتنة أن يجد المؤمن أممًا ودولاً غارقةً في الرذيلة، وهي مع ذلك راقيةٌ متحضِّرةٌ في حياتها ومجتمعاتها، ويجدها غنيةً في الوقت الذي تشاقُّ الله تعالى وتحارب دينه.
6- ومنها فتنة الشهرة وجاذبية الأرض وثقلة اللحم والدم، وهي الطامة؛ لأنها مؤيدة بطبع الإنسان وفطرته.
7- ومنها فتنة إبطاء النصر وطول الطريق.
8- ومنها فتنة الغرور، والاتكال على النفس بعد النصر.
هذه الأنواع كلها تَعرِض للمؤمن في هذه الطريق، والفائز بحقٍّ مَن أخلصَ دينَه للهِ واستطاع أن يتجاوزها وهو في طريقه إلى الله تعالى وجناته.
لذلك كان الرسول- صلى الله عليه وسلم- هو المثل الأعلى والقدوة الحسنة ليتعلَّموا منه الصبر والثبات وتحمُّل الأذى في سبيل الله والإخلاص لهذا الدين، كما تعلموا منه الصلاة والصيام وسائر العبادات.
إن الإيمان ليس كلمةً تقال، إنما هو حقيقة ذات تكاليف وأعباء، وجهاد يحتاج إلى جهد، ولا يتحقق ذلك كله إلا بإخلاص المخلصين، فكان لا بد أن يتعرضوا للفتنة فيثبُتوا عليها ويخرجوا منها صافيةً عناصرُهم خالصةً قلوبُهم.
والمسلم الذي يقول للبشرية جئنا لنُخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جَور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة يَشعُر بذلَّة وتفاهة قبل الالتحاق بهذه الدعوة وبشرف الانتساب إليها يقول: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغي العزة في غير الإسلام أذله الله.
إن حقيقة هذا القول لا بد أن يُترجَمَ إلى سلوك يجعله يقول لكل جبار: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (72) إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا﴾ (طه).
فكم من رجال في عصرنا الحديث ثبتوا وضحَّوا وهم يحملون هذه الدعوة دون تغيير ولا تبديل ولا تعطيل، ما أرهبهم سيفُ الحجاج، ولا أغراهم ذهب المعزّ، ومكثوا عشرات السنين في السجون والمعتقلات أمناء على دعوتهم، مخلصين لرسالتهم، لا تحدُّهم أرضٌ ولا يرهبهم عذابٌ، يردِّدون:
نحن عصبة الإله
- دينه لنا وطن
نحن جند مصطفاه
- نستخفُّ بالمحن
وصدقت عائشة- رضي الله عنها- حين كتب لها معاوية: أن اكتبي إليَّ كتابًا توصيني فيه، ولا تُكثري عليَّ، فكتبت عائشة- رضي الله عنها- إليه: السلام عليك.. أما بعد، فإني سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: "من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس" والسلام عليك.
والذي نريد أن نؤكد عليه أنه يتكرر في تاريخ الدعاة إلى الله موقف أعداء الحق في مضايقة الدعاة، ومحاولة إخماد صوت الحق، والتفنُّن في أساليب الصدِّ عن نشر دين الله، وإبلاغه إلى مسامع العامة من الناس، وافتعال المبررات- أمام العامة من الناس- لضرب الدعاة إلى الله تعالى؛ حيث يلصق بهم من الافتراءات والدعاوى المضللة ما يجعل منه مسوّغًا لضرب الدعوة وحمَلَتِها الذين وهبوا أنفسهم لله تعالى، وأخلصوا دينهم لله، وثبتوا أمام الضربات الشرسة المتكررة.
وبهذا البلاء يزيد رصيدُ المؤمنين ومقامُهم عند الله، فهو يرفع به درجاتهم وحسناتهم، ويكفِّر به خطاياهم، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (147) فَآتَاهُمْ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (148)﴾ (آل عمران).
وبهذا الإخلاص للدعوة يتطهَّر الصفُّ المسلم من أدعياء الإيمان والذين في قلوبهم مرض؛ إذ إن المسلمين لا يعرفون دخيلة النفوس ولا حركة القلوب، ويقيسون الناس بظاهرهم، فيأتي البلاء ليكشف المخلصين الصادقين من المنافقين الكاذبين، فيتميز بذلك الصف ويختار المولى من ينصر بهم دعوته.
7- الحرص على توريث الدعوة مجردة عن الأشخاص
فلا يجب على الداعي أن يدعو أحدًا لشخصه وذاته ويجمع الأفراد حوله، ويصنع لنفسه زعامةً، بل من الإخلاص أن يدعو للفكرة فإذا تعلَّق المدعو به قام بعملية "فطام" تجعله يعتمد على نفسه ويعمل لفكرته ويتجرد لدعوته؛ لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فالأفراد متقلبون- إلا من رحم ربك- أما الفكرة فثابتة لا تتغير، ومن الأمانة أن يتعلق المدعو بالثابت لا المتغيِّر ولا تربطه بالداعي إلا رباط الأخوَّة؛ فإن انحرف الداعي بدعوته أو غيَّر وبدَّل أو زلَّت قدمه بعد ثبوتها التزمَ المدعو الطريقَ وثبت على الصراط وقال لمن دعاه: هذا فراق بيني وبينك.
درس من الإمام البنا
إن الشعور بالمسئولية تجاه الجماعة هي التي جعلت عمر بن عبد العزيز يقول: "ألا إني لستُ بخيركم، ولكني رجل منكم غير أن الله جعلني أثقلَكم حملاً، فالقيادة ليست مغنمًا يتمتع به القائد، ويتلذَّذ بعبارات الثناء عليه، بل هي عناءٌ وتبعةٌ، وقد ضرب لنا الإمام البنا- رحمةُ الله عليه- مثلاً رائعًا بدار جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة عام 1938م حين وقف يخطب فتحمَّس أحد الإخوان من الطلاب فهتف بحياة حسن البنا، ومع أنه لم يردِّد الحاضرون هذا الهتاف إلا أن فضيلته وقف صامتًا لا يتحرَّك برهةً فاتجهت إليه الأنظار في تطلُّع، ثم بدأ حديثه في غضب، فقال: أيها الإخوان.. إن اليوم الذي يُهتَف بأشخاص لن يكون، ولن يأتي أبدًا.. إن دعوتنا إسلامية قامت على عقيدة التوحيد فلن نحيد عنها.
أيها الإخوان.. لا تنسوا في غمرة الحماس الأصولَ التي آمنَّا وهتَفْنَا بها: الرسول قدوتنا ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56)﴾ (الأحزاب).
وبهذا الموقف وضع الإمام الشهيد شباب الدعوة أمام صورة حية للمحافظة على جوهر الدعوة والاستمساك بها، وعدم التعلق بالأشخاص مهما كانت مراكزهم وهم في مسيرة العمل الإسلامي.. إن العلاقة بين أفراد الجماعة تقوم أساسًا- بعد الرباط الإيماني القائم على الإخلاص- على الرباط التنظيمي القائم على الثقة المنبثقة من الحب في الله.
من مهام الرسل توريث الدعوة
إن الحرص على توريث هذه الدعوة مهمة الرسل والأنبياء الكرام، فهذا إبراهيم عليه السلام ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (131)﴾ (البقرة) فلم يكتفِ عليه السلام بنفسه إنما تركها في عقبه، وجعلها وصيتَه في ذريته ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (132)﴾ (البقرة) حرصٌ واجتهادٌ في ألا يتركوا هذه الأرض إلا وهذه الأمانة محفوظة فيهم.
توريث أسلوب الدعوة
ومن الإخلاص أيضًا أن تكون أمينًا فيما تريد أن تورِّثه، فتسلمه كما استلمته دون إفراط ولا تفريط، فهمًا ودعوةً وتطبيقًا، فمن الأمانة حين نورِّث الدعوة لمن بعدَنا أن نحرص على أن نبيِّنَ لهم أن إجبار الناس وقسرهم لا يفيد، فنحن نرفض مسلك العنف والإكراه رفضًا قطعيًّا؛ انطلاقًا من قول الله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125)﴾ (النحل) كذلك لأن هذا المنهج في الدعوة إلى الله خطواته مرسومة، وقواعده محددة، وأصوله معلومة مَن أخلص في تطبيقه فتَحَ الله له القلوب الغلف والأعين العمي والآذان الصمّ.
إن عظمة القائد تقاس بعظمة الرجال الذين خلَّفَهم بعده، وعدد الرجال الذين ربَّاهم في مدرسته، وبما تركه من مبادئ وقيم ومُثُل ربَّاهم عليها، فيكونون بذلك امتدادًا لطريقه، واستمرارًا لدعوته، وحُفَّاظًا لفكرته، وموصلين لرسالته.. رجالاً لا يكملون ما بدأه فحسب، بل يورِّثون هذه الدعوة أيضًا لمن جاء بعدهم وهم يرددون ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10)﴾ (الحشر) وهكذا تصبح الدعوة ولاَّدة،كلما جاءت أمة تسلمت من أختها الراية وهم منون بربهم، مستمسكون بكتابهم، يشعرون بعظمة رسالتهم، ويعتزُّون بالانتساب إليها، ويثقون في نصر الله لها، داعين إليها دون إكراه، مبلِّغين رسالتها دون عنف، يورِّثون دعوتَهم تعريفًا وتكوينًا وتنفيذًا كما آمنوا بها فهمًا وتطبيقًا.
8- بذل الجهد واستخدام كل الوسائل المتاحة لتكوين رأي عام حول الدعوة
لنشر الدعوة أهمية كبرى في حياة الداعي المخلص، فهو يبذل قصارى جهده في نشرها بالقول ملفوظًا أم مكتوبًا أو مقروءًا؛ ذلك لأن الإخلاص يفتح القلوب وتهوي إليه الأفئدة وتنصت له الآذان، طالما أن الداعي يستخدم قواعد أصول الدعوة إلى الله، والداعي لا يقف عند حد القول باللسان بل يستخدم وسائل التبليغ المتاحة وهي اليوم كثيرة ومتعددة ومتنوعة، مثل:
1- الوسائل المسموعة كالإذاعة والندوة والخطبة والمناقشة والدرس.
2- الوسائل المقروءة مثل الصحف والمجلات والكتب والنشرات.
3- الوسائل البصرية مثل التلفاز والسينما والفيديو.
4- الوسائل الشخصية، مثل المقابلة والدعوة الفردية والمحادثات والمجاملات.. إلى غير ذلك.
وبهذه الوسائل المتنوعة يسعى بدعوته لتصل إلى جميع شرائح المجتمع وطبقاته، ليُكوِّن رأيًا عامًّا يحمل أفكاره وتصوراته ويؤمن بطريقه ويتعاطف معه مع أقل تقدير إذا لم يضحِّ من أجله، وهذا الجهد الذي يبذله الداعي لا ينتظر أمرًا به من القيادة ولا توجيهًا من أمير، إنما هي حركة تلقائية؛ لأنه مكلَّف بها سلفًا من قِبَل الله- عز وجل- يشعر بها ويؤديها كل مخلص لدعوته لتنتشر في الآفاق، كما فعل هدهد سليمان عليه السلام.
إنه إخلاص الداعي الذي يبذل الطاقة ويدعو إلى دين الله؛ لينتشر بين الناس جميعًا، ويكوِّن رأيًا عامًّا لدعوته لا ينتظر تكليفًا من قيادة، إنما هي تلقائية، الحركة بدافع الإخلاص لها؛ ليحمل هذه الدعوة ويتعاطف معها الناسُ على أقل تقدير، وليكوِّن رقابةً من الرأي العام على كل فرد من أفراد الأمة؛ مما يجعل له أحسنَ الأثر في المحافظة على سلامة المجتمع، وحماية الفكرة وإحلال الصالحة منها محلَّ الفاسدة، فيحفظ بذلك كيان الأمة ويُظهر شخصيتها المسلمة.
إن الدعوات لا تنتصر بأصحاب المصالح ولا بطلاب الأضواء وعبَّاد الشهرة والظهور، بل بمن سماهم الحديث الشريف: "الأبرار الأتقياء الأخفياء.. الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، قلوبهم مصابيح الهدى"، ولذلك نصح الإمام البنا أتباعَه بأن يبعدوا بدعوتهم عن هيمنة الكبراء والعظماء وأصحاب الأموال.
الإخلاص للجماعة أفرادًا وقيادةً
المسلمون المخلصون لدينهم اليوم هدفهم تأسيس مجتمع إسلامي، وهذا الهدف السامي يحتاج إلى جماعة تُقيم الإسلام أولاً في واقع حياتها حتى يرى الناس فيهم القدوةَ الصالحةَ، والمُثُل العُليا، والأخلاق الفاضلة، ويرَوا محاسنَ دين الله تعالى قد أقاموه في نفوسهم أولاً، فيدركوا أثَرَ هذا الدين فيمن آمَن به، ويشعروا بعظمته عندها يسارعون إلى الدخول فيه.
وهذا كله يشجعهم الأفراد في الجماعة المسلمة الذين تحلَّوا بالإخلاص على إبراز معالم شخصيتهم الأخلاقية وهم يتعاملون فيما بينهم، فإن شعر الناس بأخلاقهم التي تُرجمت حياةً سلوكيّة، أحسوا بالنموذج الفذّ المشرِّف الذي يفتقدونه في حياتهم، فيسرعون للانضمام إليهم، فتزداد قاعدتهم وأنصارهم بفضل إخلاصهم لمنهجهم وإخلاصهم لجماعتهم، ولكن الإخلاص للجماعة ليس كلامًا يُحفظُ ونصوصًا تُكتب أو تُقرأ بل له دلائله.. فما هي دلائل الإخلاص للجماعة جندًا وقيادةً؟! هذا ما سوف نتعرف عليه في الجزء الثاني..
- المصدر: إخوان أون لين